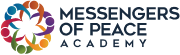
Blog entry by Sam Sam
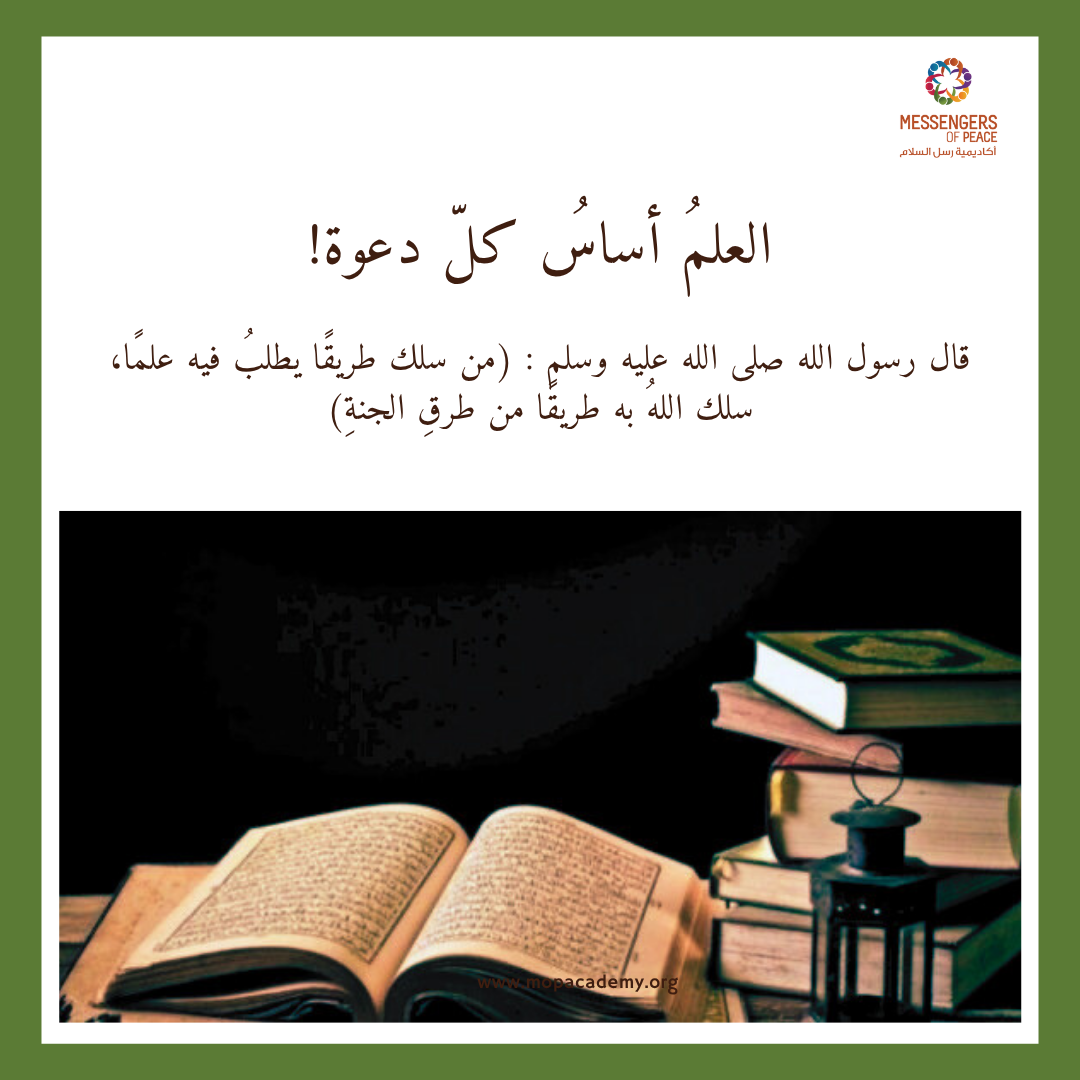
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإنّ رسالة الدعوة إلى الله تُعدُّ من أشرف المهام، وأساس نجاحها رهينٌ بتمكّن الداعية من العلم الشرعي والفقه في الدين، فالعلم نورٌ يُضيء طريق العبادة والمعاملة، ويرفع أهله درجاتٍ كما أراد الله، وهو الإرثُ الخالد الذي ورثه الدعاة عن الأنبياء -عليهم السلام-، ومن لم يتسلح بهذا السلاح ضلَّ عن الجادة، وأضلَّ معه الخلق.
وقد جاء في حديث رسول الله ﷺ أنه قال: (إنَّ اللَّهَ لا يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ العِبَادِ، ولَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بقَبْضِ العُلَمَاءِ، حتَّى إذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا فأفْتَوْا بغيرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وأَضَلُّوا)-رواه البخاري.
وهناك ارتباطٌ وثيقٌ بين سعة علم الداعية وفعالية دعوته ونجاحها ولو تأخر ذلك، وتتجلى بركة العلم في جانبيْن أساسييْن:
الأول: تأثير العلم في ذات الداعية، حيث يُصحّح عقيدته وعبادته، فيزداد حرصًا على الطاعات، وبُعدًا عن المنكرات، فالعلم الحقيقي ليس مجرد حفظٍ للمسائل، بل ما نفع القلب وظهر في السلوك، كما قال الحسن البصري: "العلم علمان: علم في القلب (وهو النافع)، وعلم على اللسان (وهو حجة الله على العباد)".
ولذلك جاء في الحديث عنه -عليه الصلاة والسلام-:(من سلك طريقًا يطلبُ فيه علمًا، سلك اللهُ به طريقًا من طرقِ الجنةِ، وإنَّ الملائكةَ لتضعُ أجنحتَها رضًا لطالبِ العِلمِ، وإنَّ العالِمَ ليستغفرُ له من في السماواتِ ومن في الأرضِ، والحيتانُ في جوفِ الماءِ، وإنَّ فضلَ العالمِ على العابدِ كفضلِ القمرِ ليلةَ البدرِ على سائرِ الكواكبِ، وإنَّ العلماءَ ورثةُ الأنبياءِ، وإنَّ الأنبياءَ لم يُورِّثُوا دينارًا ولا درهمًا، ورَّثُوا العِلمَ فمن أخذَه أخذ بحظٍّ وافر) -صحيح أبي داود.
لذا وجب على الداعية أن يكون عالمًا عاملاً معلِّمًا؛ ليتحقق فيه وصف النبي ﷺ: "مَثَلُ ما بَعَثَنِي اللهُ بِهِ... كَالْغَيْثِ أَصَابَ أَرْضًا فَأَنْبَتَتْ كَلَأً كَثِيرًا" -رواه البخاري.
الثاني: دور العلم في التبليغ والحكم بين الناس، فكيف يبيّن الداعية الحلالَ والحرامَ وهو جاهلٌ بذلك وجاهل بأصول الدين؟
إنّ استبانة الحق من الباطل تحتاج إلى بصيرةٍ نابعةٍ من الفقه، والداعية الجاهل ضالٌّ مضلٌّ، لا يُرجى من دعوته صلاح ولا هداية شرعية.
ولقد ضرب النبي ﷺ أروع الأمثلة في تشديده على العلم، فعلَّم الصحابة قولًا وفعلًا:
١- صلى وقال ﷺ: (صلُّوا كما رأيتموني أصلّي) -رواه البخاري.
٢- توضأ وقال ﷺ: (من توضأ نحو وضوئي هذا....) -رواه البخاري ومسلم.
٣- طاف بالكعبة في حجته على بعيرٍ ليريهم هيئة الطواف، كما في حديث جابر -رضي الله عنه- في صحيح مسلم.
٤- صلّى الضحى في بيت أم هانئ ليعلمهم السنن، كما روى البخاري.
وحثَّ ﷺ على تبليغ العلم ولو بالقدر اليسير، فقال: "نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا ثُمَّ أَدَّاهَا"، وأمر يوم الفتح: "لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ"، فهذا يُزيل شبهةَ امتناع بعض المسلمين عن الدعوة بحجة نقص العلم؛ فالمطلوب تبليغ ما تيسر من العلم الذي تعلمه وأنت واثق من تعلمك له، مع مواصلة التعلم، إذ لا يستوي العالم والجاهل، قال تعالى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (الزمر: 9).
والتاريخ يشهد بأن القرآن رفع مكانة عمرو بن سلمة إمامًا لقومه، وأن علم ابن عباس بالتفسير جعل عمر -رضي الله عنهم أجمعين- يُقدّره ويستشيره.
وقد جسّد ابن عباس -رضي الله عنهما- معنى السعي الدؤوب للعلم، فلم يثنه صغر سنه عن تتبع الصحابة، حتى صار "ترجمان القرآن" بعد رحيلهم.
إنّ طريق الدعوة لا يُسلك بطريق الجهل، بل بنور العلم الذي يهدي إلى صراط الله المستقيم، وعلى الداعية أن يجعل شعاره قول ابن مسعود رضي الله عنه: "عَلَيْكُمْ بِالعِلْمِ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَتَى يُفْتَقَرُ إِلَيْهِ"، فالعلم رفيقٌ وقت السعة والضيق، وسلاحٌ لا يخذل، وليذكر الداعية دائمًا أن الله يرفع بالعلم أقوامًا، ويحيي به القلوبَ كما يُحيي الغيثُ الأرضَ الموات، فمن جدَّ في طلبه فقَّهه الله في دينه، وجعله نورًا يُستضاء به في دياجير الظلام، قال ﷺ: (من يرد الله به خيرًا يفقّه في الدين) -رواه البخاري.
اللهم علّمنا وفقّهنا في دينك وشرعك واجعلنا من الداعاة العاملين المتمسكين بسنة نبيك محمد ﷺ.